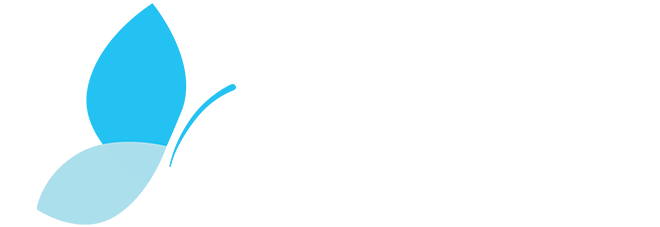رأي/ أجدني مضطرًا للعودة مجددًا إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها اختراق الأحزاب السياسية في السويد، وكيف تحولت من فضاءات نضالية تحمل مشروعًا أيديولوجيًا، إلى أنظمة إقطاعية قائمة على ريع الهويات. يمكن ملاحظة أن بعض الأحزاب قد تحولت إلى أدوات للتحكم في الوعي الجمعي. فهي تساهم في صناعة الوهم من خلال ترويج أفكار سطحية هلامية، تعزز التسطيح الفكري بتقديم حلول ترقيعية بسيطة لمشاكل معقدة، بل تعمل على ترسيخ عقلية القطيع التي تفرض رأي اغلبية مسطحة على حساب التفكير النقدي والفردي المعزول على الهوامش. وقد أفرغت هذه الأحزاب من بعدها الأيديولوجي، وطردت النخب الفاعلة وأرغمت بعضهم على الرحيل، وهمّشت الكفاءات التاريخية للأحزاب. وصل الحال بها إلى أنها تحولت إلى أقبية مافيوية، تنتج الزبونية والانتهازية والريع وعقليات القطيع وتهجين الأحزاب، لا الفكر ولا السياسة و الإنتاج و لا الحلول ولا المبادئ أي نقيض الدور الحقيقي المنوط بكل الاحزاب….
وهكذا، لم تعد الأحزاب تنتج أطرًا سياسية فاعلة، بل باتت تفرخ أطرًا ريعية تنتمي إلى مجموعات مغلقة. هذه المجموعات لا تنخرط في المعادلة السياسية من موقع وعي أو مشروع وطني مشترك حقيقي وليس هجين او مزيف، بل من موقع الهوية المجردة: اللون، الأصل، الدين، الجنس والاجندات الريعية… أي كتلة تصويتية يمكن تعبئتها حسب الحاجة، دون أي اعتبار للكفاءة الفكرية أو العلمية. هذه المحاصصة الهوياتية أي الهوية السياسية العقيمة لأنها لا تخضع لأي مراجعة أو تأهيل، بل يتم توريثها جيلاً بعد جيل.
لقد أصبح لهذا النظام الهوياتي هرم فيودالي واضح: في القمة، هناك “الكتلة السويدية البيضاء ” التي تستمد قوتها من شبكات الهويات الكبرى والنفوذ العميقة. هذه القوة لا يمكن زحزحتها أو مساءلتها، لأنها ببساطة تحتكر السلطة الرمزية والمادية، وتُورَّث كما يُورَّث الحكم في الأنظمة التقليدية. ومن هناك، يبدأ السلم الاجتماعي بالنزول تدريجيًا، وصولاً إلى القاعدة. حيث يبرز المهاجرون في صنفين: الأول، “عبيد الأسياد” الذين يؤثث بهم المشهد السياسي ولديهم خلفية جماهيرية يمكنها التصويت لصالح الأسياد في القمة، لكن مع ذلك يمكن الاستغناء عنهم أو استبدالهم حسب الحاجة والدور والصلاحية. الصنف الثاني، هو “عبيد في الحقول” الذين يُستَخدمون من قبل عبيد الأسياد ككتل تصويتية للأحزاب السياسية لتعم المنفعة وتصل الى الكتلة السويدية البيضاء في القمة، دون أن يُقدّم لهم شيء يذكر سوى وعود فارغة و أوهام تملأ الفراغ العاطفي، بدلاً من الحلول الملموسة لمعالجة انشغالاتهم وتحقيق تطلعاتهم.
وبذلك، فقدت الانتماءات الى الأحزاب السياسية مذاقها، وأصبحت المبادئ الحزبية والأيديولوجية تفتقر إلى المعنى، ولم تعد تحمل القيمة التي كانت تميزها في أوج قوتها. الأحزاب التي كانت تتمسك بمبادئ ثابتة، اختفت من المشهد السياسي، وانحرفت عن القيم والمبادئ المسار القبلي الصحيح. اليوم، أصبحت الأحزاب مخترقة؛ حيث نرى أن أحزاب اليسار باتت أقرب إلى الاشتراكية، بينما تحولت الأحزاب الاشتراكية إلى اليمين أو اليمين الوسطي، وتبنت الأحزاب الوسطية نهجًا هجينو أضعف، بينما أصبح اليمين أكثر تطرفًا، وتحولت الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى أحزاب قومية ووطنية.
هنا تبرز مسألة جوهرية: هل حقا انتهى عصر الأيديولوجيات، أم أن الأيديولوجيات تعيش فترة خمول وشيخوخة و خواء نتيجة غياب حراسها؟ هل أصبحت الأحزاب عاجزة عن تجديد آلياتها بسبب غياب النخبة التقدمية القادرة على إحداث الفارق والتغيير الحقيقي داخلها؟ أم أن هذه الأحزاب قد تم اختراقها بالفعل والسيطرة عليها من قبل أجندات خفية تعيق تقدمها وعملية الإصلاح والتجديد الجذري، وتستبعد النخبة الحقيقية؟
وكل هذه التبعات انعكست سلبًا على مفاهيم أكثر قداسة، حيث أصبح الانتماء للوطن اليوم معضلة متعددة الأبعاد، وأخذت الوطنية أشكالًا هوياتية متنوعة وضيقة، مما أصاب مفهوم الوطنية الشاملة والوطن المشترك القائم على فهم عميق للعدالة والتنوع الثقافي بشلل كلي، وليس جزئي. الوطنية ليست انتماءً للهويات الضيقة أو المجموعات المغلقة، ولا هي تقليد أعمى في المظهر أو الملابس أو الشكل والنطق، ولا هي مسخ أو تهجين للثقافات وفرض تحديات عليها أو دعم لاصطفافها في هويات أو مجموعات مغلقة وأحيانا متطرفة. عندما نفهم معنى الانتماء ومعنى العدالة، ومعنى التنوع الثقافي، ومعنى الهوية الوطنية الواعية، حينها سيتحقق التكامل الاجتماعي، وتصبح الوطنية والولاء للوطن الكبير أمرًا تلقائيًا.
ليس هذا فحسب، بل حتى أحزاب اليمين أصبحت تتلاعب بهذه الفئات الاجتماعية المستغلة، مقدمة لهم التنازل عن الجنسية مقابل مبالغ رمزية، وتستغلهم بشكل فاضح، مع إهدار حقوقهم في التقاعد، بل وتحويلهم إلى أكباش فداء ومناديل تمسح فيهم فشل سياسة الهجرة والاندماج، بالإضافة إلى استغلالهم لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، بينما تم تجاهل القضايا الأكثر جوهرية مثل العدالة الاجتماعية والتعليم و الصحة ووسوق العمل والرفاهية وفي المقابل، لا أحد يعارض هذا العبث، وكأن الجميع شريك في الجريمة، مما يعزز الفرضية بأن الانتماء والجنسية لم يعدا يُفهمان من خلال الحقوق الأساسية والقانونية والأخلاقية، بل أصبحا يرتبطان أيضًا بأبعاد عرقية وهوياتية.
نعم، السبب هو أن الأحزاب بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتجديد جذري في أيديولوجياتها وهياكلها الداخلية، بالإضافة إلى اختيارا قادة أكفاء. لقد أصبحت النخبة الحالية نخبة مزيفة خاملة، مفلسة سياسيًا، جاءت عبر نظام التوريث الحزبي القائم على الولاء للأشخاص والمصالح الشخصية والهويات الضيقة، وليس على أساس الكفاءة والمعرفة. أما النخب الحقيقية، فقد تم تهميشها أو طردها، وتعرضت للمؤامرات من قبل اللولبيات التي تتحكم في الاحزاب.
نظام التوريث هذا لا يعمل بشكل عشوائي، بل عبر آليات دقيقة، تبدأ من الجمعيات الحزبية، التي يفترض أنها تمثل جزءًا من الدينامية الديمقراطية، لكنها في الواقع تحوّلت إلى وكر وأدوات لتمثيل هويات وعائلات وأعراق تكاد تندثر أو كادت تذوب في الدولة المدنية الحديثة سابقًا. لذلك، لجأت إلى الأحزاب لإعادة إنتاج ذاتها وهويتها الأصلية، لا من أجل مشروع وطني مشترك، بل من أجل النفوذ والسلطة التي ستكون لها انعكاسات خطيرة على مفهوم الوطن المشترك والوطنية الشاملة.
أما الجمعيات الحزبية، فقد أصبحت بدورها أدوات للريع السياسي، يديرها في كثير من الأحيان أفراد يفتقرون إلى الكفاءة، يخشون أصحاب القدرات الحقيقية، ويحيطون أنفسهم بجماعات سطحية متجانسة في هويتها، لا يجمعهم أي مشروع فكري أو وطني حقيقي، بل روابط عاطفية ومصالح ضيقة تسيطر عليها الانتهازية.
وهكذا، اغتيلت ووئدت الأيديولوجيا في العديد من الأحزاب، ولم يبقَ منها سوى الأسماء والشعارات، بينما تحوّل عمقها وجوهرها إلى أعشاش للدبابير وساحة صراع لتصفية الحسابات الضيقة بين هويات مغلقة تتقاتل داخل قوالب حزبية بالية ومهترئة ومفلسة سياسيا. لم يعد الهدف بناء الوطن أو صياغة مشروع مشترك، بل حل محله تعزيز الانتماءات الضيقة المتطرفة من أصل، أو عرق، أو ولاء عاطفي لهوية او مجموعة.
في هذا المناخ، لا مكان لمن يجرؤ على التفكير النقدي أو يدعو إلى الإصلاح. فمصير العضو الذي يخرج عن الصف يُحدَّد سلفًا داخل آلية ديمقراطية مخترقة، أو ما يشبه “ديمقراطية مزيفة” حسمت يوماً مصير سقراط، لا لأنه خان المدينة، بل لأنه فكّر بحرية، لذا قررت مصيره أغلبية ضئيلة من الجهلة.
ومن هنا بدأ الاختراق الحقيقي، ليس فقط للأحزاب، بل للديمقراطية نفسها. أصبحت وسيلة تُستغل من قبل هذه الهويات، وأحيانًا من قبل استخبارات دولية تستفيد من غياب الكفاءات الحقيقية داخل القيادات الحزبية نتيجة لديمقراطيات الهويات أو ديمقراطيات القطيع التي تُنتج وتُرفّع نخبة فاسدة وقادة فاقدي الكفاءة. هذه القيادات تفتقر إلى القدرة على التحليل أو تفكيك الشيفرات السياسية والأمنية والاجتماعية، مما أسفر عن نتائج كارثية انعكست سلبا على المجتمع الذي أصبح اليوم ممزقًا إلى فصائل متناحرة.
وهكذا، تواصل هذه القيادات المفلسة، التي جاءت عبر آليات التوريث الهوياتية، التحكم في الأحزاب، وابتزاز النخب النوعية، وإبعادها عن أماكن صنع القرار في الأحزاب، وتهجير العقول الفاعلة، وإحاكة المؤامرات لطردها إذا لزم الأمر.
لذلك يجب التركيز على تعزيز مفهوم الوطنية الشاملة التي تقوم على العدالة والتنوع الثقافي. هذا يتطلب توجيه الأحزاب نحو تبني مشاريع فكرية حقيقية بعيدة عن المصالح الضيقة والهويات المغلقة. كما يجب تعزيز الشفافية الداخلية في عملية اتخاذ القرارات الحزبية لتفادي هيمنة اللوبيات والانتهازية. يجب على الأحزاب العمل على إعادة إدماج الكفاءات الحقيقية، وتحقيق تمثيل أكثر توازنًا يعكس التنوع الفكري والثقافي في المجتمع. وفي المقابل، يتحمل الشعب، بمختلف أطيافه، مسؤولية اختيار الحزب الذي ما زال يصطف إلى جانب الجبهة الصحيحة من التاريخ، ويدافع عن المبادئ الكبرى، لا عن المصالح الآنية والهويات الضيقة.
احمد مولاي كاتب وسياسي
مقالات الرأي تُعبر عن كتابها وليس بالضرورة عن SWED 24